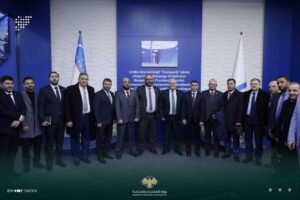بعد توحيد البلاد وإنهاء سنوات الانقسام، دخلت حكومة الرئيس أحمد الشرع مرحلة يُفترض أنها مرحلة الدولة، لكنها في الواقع مرحلة الاختبار الوجودي. فالتحديات لم تختفِ بانتهاء الصراع، بل تغيّر شكلها وانتقلت من الجبهات إلى الداخل، من السلاح الظاهر إلى الأزمات المتراكمة تحت السطح. الخطر اليوم لا يتمثل في عدو خارجي أو تمرّد معلن، بل في انفجار داخلي صامت يتغذى على الفشل المؤجل والقرارات المؤجلة.
الدولة الموحّدة لا تعني بالضرورة دولة مستقرة. التاريخ الحديث مليء بأمثلة دول انهارت بعد “النصر” لا بسببه، لأن الحكومات تعاملت مع التوحيد كإنجاز نهائي، لا كبداية لمسار شاق ومعقّد. وحكومة الرئيس أحمد الشرع تقف اليوم عند هذا المفترق تحديدًا.
أولًا: مؤسسات الدولة… الهياكل التي لا تحكم
أخطر ما يواجه الدولة اليوم هو وجود مؤسسات بلا سلطة حقيقية، وبلا ثقة شعبية. سنوات الحرب أفرغت الجهاز الإداري من كفاءاته، وسمحت بترسّخ شبكات نفوذ ومحسوبيات تحكم القرار من خلف الستار.
إعادة بناء المؤسسات ليست شعاراً سياسياً، بل معركة يومية ضد الفساد، التداخل، وغياب المساءلة. المواطن لا يشعر بوجود الدولة حين يسمع خطاباً، بل حين ينجز معاملة، أو يحصل على خدمة، أو يرى قانونا يُطبق على الجميع. استمرار المؤسسات بوضعها الحالي يعني دولة اسمية، وسلطة عاجزة عن إدارة الأزمات، ما يفتح الباب أمام بدائل غير رسمية تملأ الفراغ.
ثانيًا: الملف الأمني واحتكار السلاح… الدولة أو اللا دولة
لا يمكن الحديث عن استقرار بينما السلاح موزع خارج إطار الدولة. تعدد القوى المسلحة، حتى لو رُفع عنها الغطاء السياسي، يبقى خطرًا وجوديًا. احتكار السلاح ليس إجراءً تقنيًا، بل إعلان سيادة.
أي تهاون في هذا الملف سيحوّل الدولة إلى وسيط بين قوى الأمر الواقع، لا مرجعية فوقها. الأخطر أن السلاح غير المنضبط يخلق اقتصادًا موازٍيًا، ويغذي الجريمة المنظمة، ويمنح بعض الأطراف قدرة على فرض شروطها بالقوة. الدولة التي لا تحسم هذا الملف سريعًا، ستدفع ثمنه مضاعفًا لاحقًا.
ثالثًا: الاقتصاد… الجبهة الأكثر اشتعالًا
قد تنجح الحكومات في تأجيل الأزمات السياسية، لكنها لا تستطيع تأجيل الجوع. الأزمة الاقتصادية اليوم هي المحرّك الأخطر للغضب الشعبي. ارتفاع الأسعار، تآكل القدرة الشرائية، البطالة الواسعة، وانسداد الأفق أمام الشباب، كلها عوامل تُراكم احتقانًا صامتًا.
الخطاب الوطني يفقد قيمته حين يعجز المواطن عن تأمين أساسيات حياته. وغياب خطة اقتصادية واضحة، عادلة، ومعلنة، سيحوّل الصبر الشعبي إلى نقمة. التاريخ يقول بوضوح: الثورات والانفجارات لا تبدأ بالشعارات، بل بالفواتير.
رابعًا: العدالة الانتقالية… الحقيقة المؤجلة
توحيد البلاد لم يُنهِ ذاكرة الدم. آلاف الضحايا، المعتقلين، المفقودين، والمظالم المتراكمة لا يمكن تجاوزها بالصمت. تجاهل العدالة الانتقالية بحجة “الاستقرار” هو رهان خاسر، لأن المجتمعات لا تنسى، بل تنتظر.
العدالة لا تعني الانتقام، بل الاعتراف، المحاسبة، وجبر الضرر. من دون مسار واضح وشفاف، ستبقى الجراح مفتوحة، وسيظل الثأر احتمالًا مؤجلًا لا منتهيًا. لا دولة مستقرة فوق مقابر الحقيقة.
خامسًا: إدارة التنوع… الاختبار الأخلاقي للدولة
المجتمع الخارج من صراع طويل هشّ بطبيعته، وأي خطأ في إدارة التنوع قد يعيد إنتاج الانقسام بأشكال جديدة. الدولة اليوم مطالبة بأن تكون مظلة جامعة، لا طرفًا منحازًا.
الاستقواء بالهويات الفرعية، أو إقصاء أي مكوّن، أو توزيع الامتيازات على أساس الولاء، كلها ممارسات قصيرة الأجل، لكنها مدمرة على المدى المتوسط. الدولة التي تفشل في إدارة تنوعها، تفشل في البقاء.
الخطر الحقيقي: الوقت
أكبر عدو لحكومة الرئيس أحمد الشرع ليس المعارضة، ولا الشارع، بل الوقت. كل يوم تأخير في اتخاذ قرارات حاسمة يزيد من كلفة الإصلاح، ويقلل من هامش المناورة. الصمت الشعبي ليس رضا، بل انتظار. والانتظار الطويل غالبا ما ينتهي بانفجار.
الانفجار الداخلي القادم ليس حتمياً، لكنه محتمل. وهو لن يأتي على شكل حدث واحد، بل كسلسلة انهيارات: أمنية، اقتصادية، اجتماعية، تبدأ صغيرة ثم تتدحرج. منع هذا السيناريو يتطلب شجاعة سياسية، قرارات مؤلمة، ووضوحًا مع الناس.
البلاد اليوم أمام لحظة مفصلية: إما دولة تُبنى على أسس صلبة، أو وحدة شكلية تخفي تحتها أزمات قابلة للاشتعال في أي لحظة. التاريخ لا يمنح فرصًا بلا نهاية، والدول التي تخرج من الحروب لا تُقاس بما ربحته، بل بما تستطيع الحفاظ عليه.