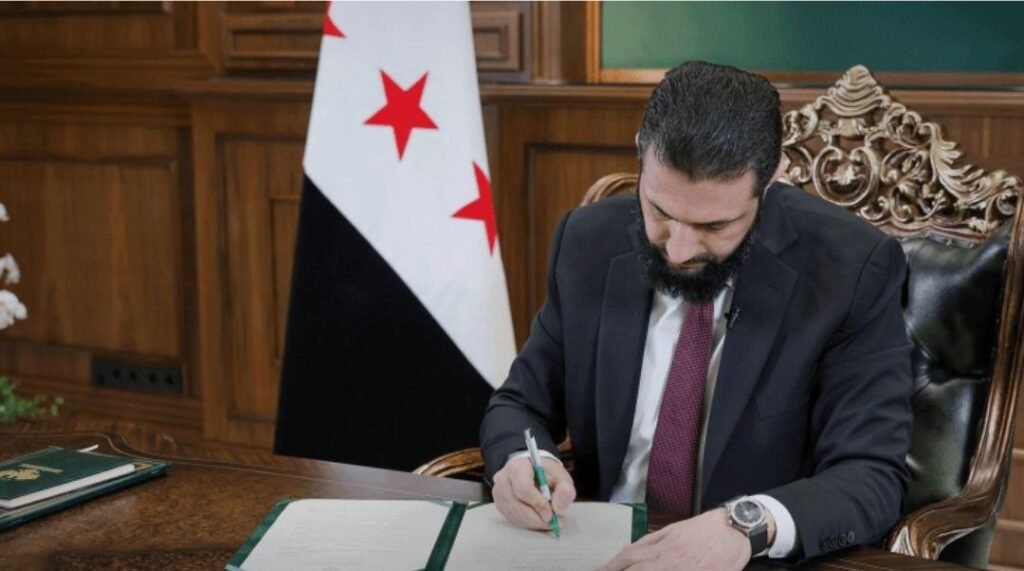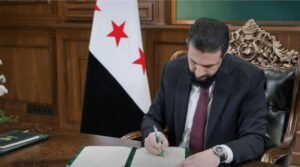في ليالي رمضان القديمة، كان للمساء هيبةٌ خاصة، وكأن الزمن نفسه يهدأ احترامًا لتلك الساعات. بعد الإفطار بدقائق، يتحوّل البيت إلى خلية نحل صغيرة؛ أمي تُسرع في ترتيب الصحون، وأبي يضبط صوت التلفاز، ونحن نتحلّق أمام الشاشة بلهفةٍ لا نخجل منها. كان الأمر موعدًا يوميًا ننتظره كما ننتظر زيارة عزيز.
ما إن تبدأ شارة ألف ليلة وليلة حتى يسكن كل شيء. ينساب صوت شهرزاد دافئًا: “بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد…”. كنا نغادر الغرفة الصغيرة إلى عوالم القصور والبحّارة والكنوز، نعيش المغامرة بكل خيالنا، ونرافق شهرزاد وهي تنسج حكاياتها لتنقذ حياتها من سيف شهريار. وعندما يقترب الفجر، كانت تلتفت إليه بحكمة تعرف كيف تؤجّل المصير، فتُوحي بأن في الغد تتمّة أعجب، وتتركه وتتركنا معلّقين بين الدهشة والانتظار. كنتُ أتضايق من صياح الديك، أشعر أنه يسرق منّا الحكاية قبل أن تكتمل.
“بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد…” جملة ما زالت تعيش في قلبي وذهني، إذ ارتبطت بأجمل ذكرياتي لشهر رمضان قديمًا. ألف ليلة وليلة، تلك الروايات الخيالية الممتعة التي كنا ننتظرها كل عام بشغف بعد الإفطار، لنغوص في قصص مثل “الثلاث تفاحات الذهبية” و”فطيمة وحليمة وكريمة”، ونحلّق مع الخيال حتى يداهمنا الفجر.
ولم تكن الحكايات وحدها زينة السهرة، فقد كانت الفوازير الرمضانية طقسًا لا يقل سحرًا، خاصة تلك التي قدّمتها النجمتان نيللي وشريهان بأجمل إطلالة واستعراض. ما زلنا نذكر فوازير “حاجات ومحتاجات” و”حول العالم” التي كانت تجمع العائلة حول الشاشة، نخمّن الإجابات، ونضحك، ونصفّق، في أجواء رمضانية لا تشبهها أيام أخرى.
هي تفاصيل وذكريات لا يعرف متعتها إلا من عاشها، خاصة جيل السبعينيات والثمانينيات، جيلٌ كان ينتظر الحكاية كما ينتظر العيد، ويؤمن أن في كل ليلة سحرًا جديدًا ترويه شهرزاد قبل أن ينتصر الصباح.
اليوم تغيّرت الصورة كثيرًا. لم تعد الشاشة قطعة أثاث ثابتة في زاوية الصالون، بل صارت في كل يد. لكل فرد سماعته، ومسلسله، ومنصّته، وتوقيته الخاص. لم نعد ننتظر حلقة تُعرض في ساعة محددة، بل نختار ما نشاء متى نشاء. تبدو هذه رفاهية كبيرة، لكنها سرقت منّا شيئًا خفيًا لا يُعوَّض.
الحكايات الآن أسرع إيقاعًا، أعلى تكلفة، وأكثر بهرجةً وإبهارًا. المؤثرات مذهلة، والصورة شديدة النقاء، والقصص تُستهلك دفعة واحدة. نشاهد عشر حلقات في ليلة، ثم نبحث عن غيرها في اليوم التالي. لا وقت للانتظار، ولا مساحة للتخمين، ولا فرصة لذلك الحوار العفوي الذي كان يمتد حتى السحور. كل شيء جاهز، مكتمل، ومتاح… وربما لهذا لم يعد يعلق في الذاكرة كما كان.
في الماضي، كان التوقيت يوحّدنا. كنا نعرف أن الجيران يشاهدون معنا في اللحظة نفسها، وأن الشارع كله يعيش القصة ذاتها. كان هناك شعور خفي بأننا جزء من مشهد أكبر من بيتنا الصغير. اليوم، حتى ونحن نجلس في الغرفة نفسها، قد نكون في عوالم مختلفة تمامًا. الصمت موجود، لكنه ليس ذلك الصمت المترقّب الذي يسبق جملة شهرزاد، بل صمت العزلة الفردية.
لم تكن الأعمال القديمة كاملة أو خالية من الأخطاء، لكنها كانت تملك روحًا. كانت تُصنع بإحساس الاحتفال، وتُعرض في إطارٍ يجعلها حدثًا يوميًا نتهيّأ له. أما الآن، فكثرة الإنتاج جعلت العمل يمر سريعًا، ويُستبدل بغيره قبل أن نمنحه حقّه من التعلّق.
رمضان ما زال يأتي كل عام، والأنوار تزيّن الشوارع كما كانت، لكن في الداخل شيء تغيّر. نفتقد لحظة الاجتماع، ونظرة أبي المركّزة وهو يحاول حلّ الفزورة، وتعليق أمي الذي يسبق الإجابة بثوانٍ، وضحكاتنا ونحن نتجادل ببراءة. نفتقد ذلك الشعور بأن الحكاية حدثٌ جماعي، لا محتوى عابر.
ربما لم تتغيّر الحكايات وحدها… ربما نحن أيضًا تغيّرنا. لكن في القلب زاوية دافئة، كلما اقترب رمضان فتحت نافذتها على تلك الليالي، حين كانت قصة واحدة قادرة على أن تجمع بيتًا كاملًا حول حلم واحد، وأن تترك في الذاكرة أثرًا لا تمحوه السنوات.